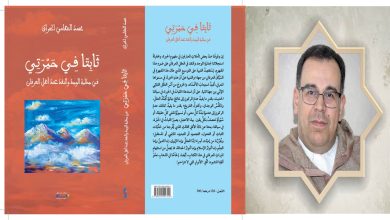ثلاثية.. التطرف والعنف والإرهاب(؟)

يميل كثير من الباحثين إلى اعتبار أن العوامل الاقتصادية هي التي تلعب الدور الرئيس، في تحديد شكل واتجاهات تطور الظاهرة ثلاثية الأبعاد: “التطرف والعنف والإرهاب”، في أي مجتمع من المجتمعات.. فهذه الظاهرة عامة، وبُعد العنف فيها، يزداد ـ حسب وجهة النظر الشائعة ـ مع تدني الأحوال الاقتصادية، ويقل في حال ازدهارها.
لذا، أصبح من المألوف، عند الحديث عن الإرهاب، أو العنف، أن تُذكَر إحصائيات البطالة وانخفاض معدلات النمو، وتدهور البنية الأساسية، وتراكم الديون وتدني الأجور.. وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية.
غير أن هذا التفسير لا يلقى قبولًا عند تيارات ومدارس فكرية أخرى؛ تلك التي ترى بدورها أن القوى الاجتماعية (الطبقات)، الفقيرة أو المُعدَمَة، قد تمارس نوعًا من العنف غير الموجه إلى سلطة الدولة، لافتقارها إلى التنظيم والنظرية التي توجه حركتها بشكل عام. بمعنى: إن عنف هذه القوى، قد يتمثل في ارتفاع معدلات الجريمة من الناحية الجنائية، دون أن يتخطاه لعنف مُوَجَه إلى سلطة الدولة.
ويعترف هؤلاء بأن الحياة العصرية، التي وفرها “المجتمع الرأسمالي”، بقيمه وتقاليده، كانت السبب الرئيس وراء ظهور نزعات “الاغتراب” والتفكك الاجتماعي؛ ومن ثم، ظهور أعمال العنف في قطاعات معينة، ترتبط بالشرائح “السِنِية” (العُمرية)، في أغلب الأحوال، وتتركز بين الشباب الباحث عن فرص للعمل وإثبات الذات.
وبصرف النظر عن مدى صحة أي من التفسيرين، فإن الملاحظة التي نود أن نسوق، هنا، في مواجهة كل منهما، أنه رغم وجود “مُعامل ارتباط” قوي، وعكسي، بين تفشي العنف والإرهاب، وبين تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ إلا أن هذا الارتباط، هو أقوى ما يكون في المجتمعات “النامية”، في حين أنه يضعف حتى يصل إلى درجة “عدم الارتباط” في مجتمعات أخرى أكثر تقدمًا.
فـ”الكساد العظيم” في الولايات المتحدة الأمريكية، في آواخر الثلاثينات من القرن الماضي، لم يولد عنفًا سياسيًا، عشوائيًا أو منظمًا، يستهدف مؤسسات الحُكم وهيبة الدولة وشرعية دستورها، رغم ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 25 بالمئة، وتدهور معدل نمو الدخل القومي الإجمالي، وانتشار حالات الإفلاس في القطاع الصناعي والزراعي والمالي، واحتشاد الباحثين عما يسد رمقهم في شوارع المدن الأمريكية الكبرى.
أيضًا، الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرَّت بها كثير من الدول الغربية المتقدمة، خاصة في أوروبا، في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي؛ تلك التي وصلت معدلات البطالة في بعضها إلى حوالي 12 بالمئة، وتدهور معدل النمو فيها إلى حوالي 1 بالمئة.. هذه الأزمة، لم تؤد إلى العنف الذي يهدد كيان الدولة، و/أو محاولة نسف النظام السياسي والاجتماعي فيها.
لكن الوضع مختلف، بالطبع، في المجتمعات “النامية”؛ حيث تكاد ظاهرة العنف السياسي الداخلي، ترتبط وتتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. إذ، قلما نجد إرهابًا أو عنفًا سياسيًا، حيث يتوافر ازدهار اقتصادي “متنامي”، وبنية أساسية مُتجددة، وتطلعات معيشية مُشبَعة.
ولعل تفسير هذه المفارقة بين المجتمعات، في مواجهتها للمصاعب الاقتصادية، هو الذي يؤكد خطورة البحث عن “الوضع الاقتصادي”، خلف كل عبوة ناسفة أو طلقة طائشة.
فمن جهة، يُنظر إلى المشكلات الاقتصادية في الدول المتقدمة والمستقرة، على أساس “الدورات” الاقتصادية المتعاقبة بين الكساد والرخاء. وهذا التفسير ـ الدوري ـ للمتاعب الاقتصادية، يكاد يستقر كفرضية أساسية في أذهان المتأثرين بها، كما في أذهان أصحاب القرار فيها. وإذا كان من جدل ـ متحضر ـ يدور حولها، فهو جدل يدور حول الأدوات النقدية والمالية والتشريعية الملائمة للتعامل معها. إنه جدل يدور حول “السياسات”، ضمن إطارات مؤسسية “شرعية” مستقرة.. ولا خلاف عليها.
لكن، من جهة أخرى، فإن الأزمات الاقتصادية في كثير من المجتمعات النامية، تفتح الجدل دائمًا حول “الأساسيات”، وتكاد تُلقي بظلالها حول الأمور الجوهرية فيها. إنه جدل حول المؤسسات، وليس حول “السياسات”. ومع ذلك، فحتى هذا الجدل وحده لا يكفي لتفسير ظاهرة العنف السياسي.
إذ، ما الذي يحدو بإنسان، أو مجموعة من الأفراد، لكي يعرضوا حياتهم وحياة “مواطنين أبرياء” للخطر(؟!).. وما الذي يُحفز أناسًا عقلاء أن يدمروا ـ بأنفسهم ـ منشآت أوطانهم، ويثيروا الرعب والخوف بين مواطنيهم، وينشروا جوًا من التوجس وعدم التأكد بين أصحاب رؤوس الأموال، سواء مواطنين أو أجانب(؟!).
من المنطقي، أن يكون هناك شعورًا باليأس والإحباط، وقناعة بالرفض المُطلق للمجتمع والدولة، وشرعية القوانين والمؤسسات فيها، وتبريرًا “عقيديًا مُوجِهًا” (أيديولوجيًا)، باستخدام العنف ـ المتطرف ـ للتعبير عن هذا الرفض وذلك الإحباط.
هنا، يمكن وضع اليد على واحد من أهم الأسباب وراء نمو ثلاثية “التطرف والعنف والإرهاب”؛ إنه ذلك المتمثل، أيضًا، في ثلاثية “الرفض والإحباط والتبرير العقيدي المُوَجِه”. ولأن هناك من القوى صاحبة المصالح في استخدام، أو بالأحرى استغلال، هذه الثلاثية الأخيرة، من أجل “تنمية” الثلاثية الأولى، والدفع بها في اتجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ لذا، تنمو الظاهرة، وتتسارع، بدءًا من التطرف في الرأي والرؤية، مرورًا بالعنف في الممارسة، وصولًا إلى الإرهاب في السلوك، الذي نلاحظه في أكثر من مكان، خصوصًا على الأرض العربية.
يبدو ذلك بوضوح، إذا ما حاولنا رصد “انتماءات” العناصر الفاعلة في جماعات العنف، في أكثر من مكان على هذه الأرض، العربية، والتي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وليس إلى الطبقات الدنيا الأشد فقرًا والأكثر عوزًا.. وهو ما يدفعنا إلى القول بأنه لا علاقة مباشرة بين تدني الأوضاع الاقتصادية، وبين انتشار هذه الجماعات. بل، تظهر جوانب أخرى أكثر ارتباطًا بالظاهرة، تتمثل في غياب القيم التي تعوض التفكيك الاجتماعي الناتج عن عملية محاولات تحديث المجتمعات العربية النامية “على الطريقة الغربية”.
وإذا كانت هناك علاقة طردية بين مستوى التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وبين مستوى السلم والأمن الاجتماعيين، فإن ما ينبغي الإشارة إليه، هنا، أن مستوى التطور “المجتمعي”، بأبعاده المختلفة، هو شيء مختلف تمامًا عن مستوى الدخل والثروة، أو الرخاء المادي. فهذا الأخير، قد يبلغ أعلى الدرجات دون أن يحمل معه السلم والأمن الاجتماعيين؛ بل، على العكس، فإنه قد يحمل معه المزيد من عوامل التناقض والتفجر والصراع.
في هذا السياق، فإننا نحتاج إلى منهجية جديدة، كليًا، للتعامل مع هذه الظاهرة. وفي نظرنا، فإن هذه المنهجية تبدأ بالاعتراف بـ”حق الاختلاف”، ووضع الأطر لحماية ممارسة هذا الحق، ما دامت هذه الممارسة لم تخرج عن الوسائل القانونية والسلمية؛ إضافة إلى الاعتراف بشرعية تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية، وإتاحة المزيد من الفرص المتساوية ـ أو حتى المتكافئة ـ لمختلف وجهات النظر للتعبير عن نفسها، ولكافة الجماعات لتطرح مطالبها، ولتعمل بالوسائل السلمية لتحقيقها.
فهل يمثل ذلك مدخلًا إلى التعامل بشكل “منهجي” مع ظاهرة “التطرف والعنف والإرهاب”(؟!)….سؤال يستحق التأمل.