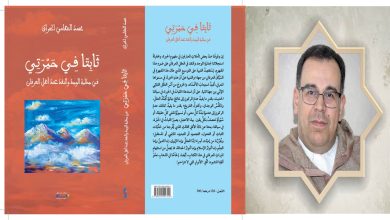منهج الرجال في الحياة

لكلّ شخصٍ منهجُه في الحياة، لكنَّ هذا المنهج ليس خاصاً به وحده، بل هناك من يتواءمون معه إجمالاً، وهناك من يتوافقون معه في معظمه.، وهناك من يتداخلون معه في بعض نِقاطِه. وليس من الضرورة أن يتعارفَ المتوافقون جميعهم فيما بينهم، رغم أنهم قد يعيشون في بقعة جغرافية مشتركة، فالحياة بمشاغلها أوسع من ذلك، ومع ذلك “فإنَّ الأرواحَ جندٌ مجندةٌ من جنودِ اللَّهِ ماتشابهَ منها ائتلف وماتباينَ منها أختلف”، ومتآلفوا الأرواح دوامُ ترابطهم أكثرُ ديمومة وأعمق بكثير من غيرهم فالعلاقات الروحية فوق روابط الدم والقربى وأنعم بهم إذا اجتمعت كلتا العَلاقتين معاً .
وقد تعيش بنفس البقعة المكانية والفترة الزمانية مع الأربعين الذين يشهبونك في صورتك لكنَّ ذلك لا يعني أنك ستنسجم معهم انسجامَك مع من يشهبونك في روحك وإن تباينت أعراقكم واختلفت لغاتكم، فنظراء الروح هم الأشقاء الحقيقيون والروحُ أقدم وجوداً وأطول خلوداً وأعمق معنىً من البدن.
أما الرجال في منهجهم – ولست أقصد بالرجال هنا من باب النوع، فليس كل من لم يجد نفسه أنثى فهو رجل ، فالرجولة بمعاييرها الخاصة وهي الأخلاق الراقية والمعادن الطيبة والمواقف المشرفة، وهو ماأنا بصدد الحديث عنه هنا بنوعٍ من التفصيل المُوجَز ، فإنَّهم رغم عيوبهم الطفيفة وإن كانوا يجهلونها أو خَفيَت عنهم ولم يعلموها أو يُعلمهم أحدٌ بها، لن يسمحوا لها – جاهدين في ذلك – أن ترزأَ بهم في حضيض الدناءة كما يحلو لغيرهم السقوط دون مبالاةٍ، فما قيمة الحياة في مستنقع المثالب؟!
ويعلمُ اللّٰهُ أنّهم أرقى من أن يكرهوا أحداً أو يحقدوا عليه، وأرحم من أن يحرقوا أنفسهم بنار الحقد وصدورُهم أضعفُ من أن تتحمل سعيرها وليسوا أغبياءً حتى ينتحروا صلياً واحتراق.
وفي ثقافتِهم بخصوص الاختلاف، فإنهم إذا اختلفوا مع من لا يوافقونهم الرأي أو الفكرة فإنّهم يجتهدون في معرفة مكانهم، فإن كانوا في المكان الصحيح حمدوا اللَّه، وإن كانوا في عكس ذلك بذلوا الجُهدَ في انتشال أنفسهم من هوى الباطل المتعصب.
وكذلك فهم لا يجعلون من الاختلاف مبرراً لبغضهم لمخالفيهم، فالإختلاف والتنوع سنة الحياة، ويبقى أطيبُ الناس خُلُقاً وأرقاهم فكراً أوسعَهم صدراً للآخر وأكثرهم قبولاً به وتفهماً له، ولايعني ذلك أنَّ كل تباينٍ مرغوب وكل اختلافٍ مطلوب، ولكن عدم الاعتراف بالاختلاف مَدعاةٌ إلى تأصيله وتوطيده أكثر، وبالقبول به أولاً وتفهمه ثانياً والحوار البناء معه ثالثاً يمكننا أن نستوعبه ومن ثم اختيار المكان الصحيح اللائق بنا جميعاً وهكذا نكونُ قد اجتزنا الاختلاف واستفدنا منه و”الحكمةُ ضالةُ المؤمن”.
ومهما بلغت بهم – أقصد الرجال – درجةُ الاختلاف مع غيرهم واشتدت بينهم حِدَّتُه واحتدّت وتيرتُه فلا يُضمِرون السوءَ ولا يتأبطون الشرَّ متربصين الفرصة للانقضاض، فالغدر صفة الجبناء والمكر حيلةُ الضعفاء، بل إنهم يستاؤون بألمٍ – لاأكثر – من تصرفات مناوئهم غير اللائقة ، ومع ذلك فإنهم يبقون على شوقٍ لأن يتفقوا معهم ويتفهمَ بعضهما الآخرَ بنديةٍ وودية، ولو وجدوا مناوئيهم في ظروفٍ تستدعي الوقوف لما أبطأوا في ذلك غير سامحين أبداً بنقاط خلافاتهم واختلافهم أن تستعرضَ نفسِها لتصنعَ التشفيَّ وتنتشي من خمر الشماتة، فهم يرون الشماتةَ جِيفةً نَتِنة لايتناولها سوى ضِباعُ الشراهة وغُراب الجِيَف، وكم حَريٌ بكل ذي عقلٍ عدم السقوط في وَحلِها، فكلٌ تمرُ عليهِ ظروفُ الدهر وصروفُه؛ وبذلك فالرجال في منهجهم الأخلاقي لايتشفون من نوازل مخالفيهم، ولايكرهُونهم أبداً لذواتهم، فإنَّ كُرهَ المرءِ غيرَهُ لذاتهِ داءٌ عُضال ومرضٌ مستعصٍ يفتكُ بصاحبهِ قبل أن ينالَ بُغيتَه.
وفي أعمالهم فهم يحاولون أن يُتقِنوها مااستطاعوا، وهم ببعد نظرهم عارفون بأنهم لا يعملون شيئاً من أجل أحدٍ سوى من أجل أنفسهم، فخيرُهم وشرُّهم مردودٌ عليهم قبل أيّ أحدٍ آخر، وإن احترموا أو تَكرَّموا وأَكرَموا ففيهم – وللّٰهِ الحمد – طِباعٌ براها اللّٰهُ فيهم لايتكلفُوها أبداً بل يجدون متعتهم وراحتهم بها شاكرينَهُ تعالى دوماً عليها .
وفي تقديرِهم للآخرين فهم يقدرون الرجال تقديراً يليقُ بمقامِهم حسب أفعالهم ومواقفهم، ومن التقدير ماترقى إلى حبٍ صادق ووُدٍ خالص، وعلاقاتٍ وطيدةٍ دائمةٍ ذات بُعدٍ إيجابيٍ أبدي.
وبهذا فقد غدوا منذُ نعومةِ أظافرِهم مُبجِّلين لمن هم فوقهم ماداموا متواضعين، ومتواضعين مع من هم دونهم حتى يتعلموا سِر خلق التواضع وغايته في الحياة، إضافةً إلى أنّه ليس هناك مايدعو إلى التكبر، فلايتكبر سوى من أضَجَّت مضجَعَه عقدةُ النَّقص الذي يتوهمه كابوساً يؤرقه في نومه ويزعجُه في صحوه، وبذلك فهو يجعل من نَقصه حقيقةً بعد أن كان ليس أكثر من وهمٍ نفسي، والتواضع من علامات الثقة بالنفس والتي هي ضرورة معنوية.
ليس فيهم ضَعفٌ وإن كانوا عاطفيين في مشاعرِهم فهذا دليلُ صدقهم، ولكنَّ كرامتَهم فوق كل شيء يطمعُ إلى التقليلِ منها دونَ وَجهِ حقّ.
إن أحبُّوا أحبُّوا بإخلاص، وإن احترموا احترموا بصدق، وإن اختلفوا اختلفوا بشرف، وإن تمسكوا بشيءٍ أو تنازلوا عنه فَبِحقٍ ولِحقّ، فلهم -ولله الفضل- عقولٌ تحكمُهم وضمائرٌ تؤنبُهم وتضبطُهم، وإيمانُهم بالله – على قدر اجتهادهم في تقويتِهم له- يوجهُهم في كل الأمور.
يمقتون الأَثَرَة ويعشقون الإيثار، وليس في قاموسهم العقدةُ الشيطانية “أنا خيرٌ منه” بل الميزة النبوية “هو أفصح مني” يحبون الخير لغيرهم ويعترفون بمزايا الآخرين ويأنفون أن تقترب من أخلاقهم حشرات الحسد والحقد والجشع والأنانية.
إن سُئِلوا أعطوا ولم يَمنَُوا أو يأذوا وإن لم يجدوا ردوا باللين معتذرين والرد باللين عطاءٌ سخيٌّ بحدّ ذاته في لغة القلوب.
وإنّهم إن أَكرَموا رأوا ذلك واجباً عليهم، وإن أُكرِموا فليس من أخلاقِهم نُكرانُ الجميل أبداً ولا نسيانُ المعروف، فأقبحُ من عدم رَدِّ الجميلِ نُكرانُه، وأسوأُ من عَدمِ جَزاءِ المعروفِ نِسيانُه، وإن كان ذلكَ المعروفُ دَيناً قَضُوه وبقي طِيبُ أثرِهِ الطيِّب في أرشيف ضمائرهم حياً مابقت الأرواحُ في الأبدان، فكريمُ الخُلق يرى مواقفَ غيرِهِ معه دَيناً وفضلاً منه، أما مواقفُهُ هُوَ فواجبٌ ولزامٌ عليه، وكما المواقفُ – في منهج الرجال – ديونٌ لابُدَّ من ردِّها، فالديونُ مواقفٌ لابدَّ من قضائها أيضاً، وليست كلُّ الديون أو المواقف مالاً فقط فهناك ماهو فوق المال بكثير، كما أن ردَّ الجميل أو قضاءَه ليس انتهاءً للقصة بل بدايةً لمشوارٍ طويلٍ من العلاقة الصادقة المتبادلة بين روحَين مُخلِصَين لايستغني أحدُهما عن الآخر، فلا غِنىً للرِّجالِ عنِ الرِّجال.
قد يُسيءُ أحدٌ الظنَّ بهم فهذا عليهِ لاشأنَ لهم به؛ لأنَّهُ يظلمُ نفسَهُ فقط، وظلمُه لنفسِه ليس على أساس كونِهم خيِّرين بعكس ظنّه، وإنَّما لأنَّ الأَولى بالمرءِ حسنُ الظنّ بالآخر – فهو فضلٌ يترقى إلى واجبٍ أخلاقي، فإن كان أحياناً حسن الظن خطأ ، فإن سوءَ الظن غالباً خطيئة، وأيضاً كان الأحرى بِمسيءِ الظنّ أن يتفضلَ بإهدائهم عيوبهم الذي جعلته يسيءُ الظن بهم وينصحهم بتركها بالتي هي أحسن، ولو فعل هذا لكانوا لهُ أُذُناً واعية وعقولاً فاهمة وقلوباً متفهمة وأَلسُناً شاكرةً داعية.
لايُحَبّذون إعطاء التبريرات وإن كانوا يلجأون إليها أحياناً من أجل توضيح أفعالٍ لهم احاطتها الظروفُ بهالةٍ من إبهام أو شابها بعضُ الغموض، فمن التبريرات ماكان لها تبريرات تسوغها بشرط أن تكون صادقة، وبذلك فهي هنا ليست خوفاً، وإنما من باب واجب التوضيح حتى لاتلتبس الأمور في نظر من يثق بهم، وقطعاً لسبيل الشيطان من استغلال أيّ فجوةٍ ليمررَ عبرَها مخططاتِه بالغةِ القبح والدناءة.
لايؤمِّلون أحداً بما لا يستطيعون أن يمنحوه ، ولا يعلقون قلوبَ الآخرين بهم وهم غير قادرين على أن يبقوها معهم، يبدأون يومَهم صريحين من أول الطريق وواضحين، وحريصين على ألَّا يتألمَ منهم أحد، وبذلك يكونون قد جبروا خواطرَ بصورةٍ سابقةٍ لكسرها الذي لن يسمحوا أن يكونوا سبباً له أو فيه.
لا يخلفون وعداً وعدوه على نية الخير ولا ينقضون عهداً قطعوه في سبيل الحقّ، ولا يبتزون أحداً بنقطة ضعفٍ فيه ولايستغلونه أو ينتهزونه، فهم لايرضون أن يعودَ وبالُ ذلك عليهم مُضاعَفاً باستحقاق.
مبدئيون ودرب مبدأهم العقل والبصيرة وغايتُه الحكمة الهادفة إلى كل مافيه خير البشرية ونعيمها ورافضون بكل إبائهم الانصهار في المجتمعات “السكيزوفرينية” ذات الأقنعة المتعددة فمن يمتلك ضميراً حياً لا يمتلك سوى وجه واحد .
بسطاء تُؤنِسُهم البساطةُ – بقدر توحشِهم من التزمُّت والتنطُّع المبالغ فيهما – ويأسرُهم التواضعُ وتستهويهم الظرافة ، وتتحكمُ بهم العَفَويّة المحسوبة والصراحة المعقولة، ولو أدى بهم ذلك إلى عِداءِ الآخرين لهم على أن يكسبوا ودَّهم بالتصنع والنفاق، والذي لايدوم قناعُ لابسِهم حتى يتهرأَ من على وجهِه منبوذاً مذموم.
ليس همُّهم رضا الناس ولا آراءهم بعد أن اعتنقوا بكلَّ قوةِ قناعتِهم المقولةَ الخالدة “رضا الناس غايةٌ لا تُدرَك” وإنَّما يسعون إلى رضا ربِّهم عبرَ دربِ نقاء القلوب وصفائها وبذلكَ تصفو لهم الحياة.
وهم رغم كل هذه الصفات النبيلة الراقية لا يتشدقون بالكمال ولا يدَّعون المثالية وإن كان الجميعُ يتمناهما، فمن يَدَّعِيهِما فقد أثبتَ على نفسهِ النقيضَ من ذلك، وجميعُنا نعيشُ على سِترَ اللّه ونقتاتُ من رحمته، ولكنّهم مجتهدون جُهدَ المُمكِن في منهجِهم لأن يكونوا أُناساً طيّبين مهذِّبين أنفسهم مااستطاعوا، وماسوى ذلك فهو توفيقُ اللّهِ لمن يحبُّ من عبادِه الباحثينَ عن هدايتِهِ الرحمانية “والذِينَ اهتَدَوا زادَهم هُدىً وآتاهُم تَقواهُم”
هذه خواطرُ معنويةٌ تفوح بالنَُبل، جرت ولا زالت في بستان الروح باعثةً الحياة ومليئةً بالجمال، طالما اختلجت بها صدورُنا وفاضت بها وجدانُنا وناشدتنا معانيها أن نصيغَها جُمَلاً وكلمات، ليست بغرضِ التفاخر ولا لِلمباهاة كما يحلو للبعض الفَهم، وإنَّما لغاية التضامن مع تلك الشاكلة من الرجال التي وافقت أرواحُنا أرواحهم – مِمَّن نعرفُهم من الإخوة والأصدقاء ، ومِمَّن لانعرفهم وهم الأكثر – حتى نبقى بحبالِ مضامينها معتصمين، حاثَّين أنفسَنا بالسير على دروبها، وداعين غيرَنا إلى أن يجعلوها منهجَهم ومذهبَهم الأخلاقي في الحياة، وكما روي عن مَثَلِنا الأعلى – صلى اللَّهُ عليهِ وسلم “ما من شيءٍ في الميزان أثقلُ من حسن الخلق” ، وهو دونَ شكٍّ علاجٌ لأمراض العصرِ وعدمُهُ سببٌ جوهريٌّ في مشاكله الآنِيَّة، فإنَّ عالمَنا اليوم بأمسِّ الحاجة إلى الأخلاقيات في عصرٍ طغت عليه المادة وصارت فيه – رُغمَ وضاعتِها – الأسمى، مجرِّدةً الروحَ من قداستهِ فلم يُقم له وزناً ولا قَدرا، وحَرِيٌّ بنا وواجبٌ علينا أن نعملَ بقدر ماأوتينا – وما آتانا ربُنا خيرٌ – على أن نُعيدَ دِينَ الروحِ – وهي الأخلاقُ – إلى ربوعِ القلوب وأصقاع الوجدان والضمائر “فَربُّ هِمةٍ أيقضت أمَّة”، هذا قصدي وغايتي وما أصبو إليه واللّٰهَ نسألُ التوفيقَ “وما تَوفِيقي إلا باللّٰهِ عَليهِ تَوكَّلتُ وإليهِ أُنِيب”.