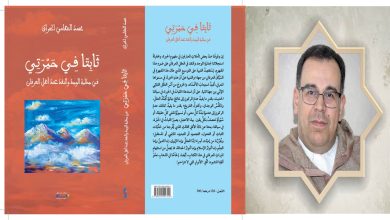ثقافة الصورة.. والجغرافيا الإعلامية الجديدة

قبل ما يُقارب ثمانين سنة، كان جوزيف غوبلز وزير الدعاية في ألمانيا، يحرض المواطنين الألمان على فتح نوافذ المساكن حتى آخر مداها، ورفع أصوات المذياع حتى أقصى درجاته، لكي تستطيع الأفكار التي يبثها من الوصول إلى أذن كل ألماني واختراقها، سواء كان راغبًا في الاستماع، أم راغبًا عنه. ولنا أن نتصور أن كثيرًا من الناس في ألمانيا، لم يكونوا يرون في ما يحرض عليه غوبلز إلا نوعًا من الإزعاج.
لكن سيرغى تشاخوتين، الكاتب التقدمي الألماني، كان يرى غير ما يراه الكثير من مواطنيه، فذهب يتابع ما يذاع، يرصده ويجمعه ويدرسه، فكان أن أنشأ مما رصد وجمع ودرس كتابًا (نشر عام 1939 خارج ألمانيا)، أعطاه عنوانًا ذا دلالة “اغتصاب الجماهير”؛ فهو انتبه إلى أن غوبلز يصنع شيئًا غير مسبوق في تاريخ البشرية بهذا الجهاز العبقري الحديث النشأة “المذياع”.
لم يكن غوبلز يملك من وسائل القهر الدعائي إلا المذياع (والصحف)، ومع ذلك نجح في أن يقنع ثمانين مليون من الألمان أن ألمانيا فوق الجميع، وأن الجنس الآري أرقى أجناس الأرض، وأن أوروبا الشرقية هي المجال الحيوي لدولة “الرايخ الثالث” (الاسم الرسمي لألمانيا النازية)، وأن أدولف هتلر قائد ملهم لا يخطئ، وأن انتصار ألمانيا هو عين اليقين.
هذا المثال، مثال غوبلز، يدفعنا إلى التساؤل: ترى، كم من الملايين من البشر كان يمكن لغوبلز أن يؤثر فيهم، لو تجاوزت إمكاناته حدود “الصورة المسموعة” إلى الصورة المرئية، تلك التي لابد من أن تأخذ موقعها في بؤرة الاهتمام وذلك من حيث أهمية الدور الذي تلعبه، خصوصًا منذ اختراع، ثم مع انتشار التلفزة(؟).
إذ، رغم ما كتبه الكثيرون حول مسألة أهمية الصورة، على مدى الخمسين عامًا الأخيرة، لكن الآن اختلف الوضع. لم يختلف الوضع بالنسبة إلى الصورة، ولا إلى تأثيرها في الناس (الجماهير)؛ لكنه اختلف بالنسبة إلى ماجريات اللحظة الإعلامية، التي نعيشها في الواقع الراهن، وما تنطوي عليه من ملامح لآفاق متوقعة، أو يمكن توقعها.
فهذه اللحظة تتسم بكونها لحظة “ثورات” تقانية – وبالطبع لا نقول: ثورة ـ في الاتصالات والمعلومات والمرئيات؛ حيث التلاقي، بل التضامن، بين تقانة المعلومات، والآلات الحاسبة في أجيالها العملاقة، والأقمار الصناعية، والكوابل المحورية، وصناعة القنوات الفضائية التي تبث البرامج والمعلومات والأخبار، وكذا الأفلام السينمائية، دون توقف، وفى تعدد وتكاثر مذهل، فوق رؤوس البشر وعيونهم، إلى درجة الهيمنة (السيطرة دون قسر) على دوائر أحلامهم ومناطق آمالهم وطموحاتهم.
نحن، إذًا، في زمن اللحظة الإعلامية، وماجريات واقعها المتمحور حول الصورة، أو “ديكتاتورية الصورة” بالأحرى. ولعل أخطر ما في هذا الزمن، هو الآفاق التي تحملها لنا التحولات التي تحدث بنا، ومن حولنا؛ خاصة بعد ما أصبحت الصورة تمثل: ليس، فقط، المصدر الأقوى لتشكيل الوعي والذوق والوجدان، عبر إمكاناتها الفاعلة في إنتاج وصناعة القيم والرموز؛ ولكن، أيضًا، المادة الثقافية الأساس التي يجرى تسويقها على أوسع نطاق جماهيري، عبر ما جرى إحرازه من نجاحات هائلة على صعيد التوظيف التقني في مجال الإعلام وآلياته.
يكفى أن نتأمل كيف بات في الإمكان أن يفيض مجال توزيع الصورة (كمنتج مرئي، ومادة ثقافية، وسلعة تسويقية)، عن حدود مجال إنتاجها (المحلى، أو الوطني)؛ ومن ثم كيف أن هذا “الفيض” يمثل بعدًا جديدًا مضافًا، على المستوى الأفقي (الاجتماعي)، تجاوزت به، ومن خلاله، الجغرافيا الإعلامية إشكاليات التمدد إلى الخارج “العالمي”. وهو تغير، ذو دلالة، في ما يخص الانتقال بالوطني والقومي إلى حال من “العالمية” بيسر بالغ، أو في ما يتعلق باختراق منظومة قيم ورموز “الآخر” الخارجي، لجل، إن لم يكن كل، ما هو محلى أو داخلي.
يكفى أن نتأمل، أيضًا ، كيف أن التعبير المرئي (المتمحور حول الصورة)، أصبح يلعب الدور نفسه الذي لعبته – من قبل – الكلمة المكتوبة، بالنسبة إلى “ثقافة المجتمع”، أو – إذا شئنا الدقة – الـ”ثقافة في المجتمع”؛ ومن ثم، كيف أن هذا “التعبير” صار يمثل اللغة، “ثقافة الصورة”، الأكثر تأثيرًا وهيمنة على مجمل الإبداعات داخل ثقافة محددة، والأداة الأكثر فاعلية في نشرها. وهو تغير، ذو دلالة، اكتسبت به الصورة على المستوى الرأسي (الثقافي)، بعدًا جديدًا مضافًا على مسار تحويلها – ثقافيًا – إلى “سلطة رمزية”.
يكفى أن نتأمل، كذلك، كيف تسنى لـ”الكتاب المرئي”، الذي يقوم على لغة الصورة ومفرداتها وبلاغتها وجمالياتها، أن يتجاوز “الكتاب المسموع”، الذي كان قد ساهم – قبل عقود – في الانتقال من الكتابة إلى الشفاهة. ومن ثم، كيف أن هذا “التجاوز”، لا يشير، فقط، إلى عمليات التهميش التي تلحق بالكتابة، وبالمفهوم التقليدي للكتاب؛ بل يؤكد، في الوقت نفسه، أن الانتقال – هذه المرة – يتوجه إلى مرحلة “الكتابة بالصورة”، إذا جاز التعبير. وهو تغير، ذو دلالة، تكتسب به “الثقافة المجتمعية”، معنى مغايرًا لذلك الذي اتسمت به في ما في سلف من الأزمنة.
إذ، عبر الكتابة بالصورة، وعبر لغتها والثقافة التي تتضمنها، و – كذا – الناتجة عنها، تتحول الصورة، أو بالأصح “ثقافة الصورة”، إلى نظام إنتاج وعى الإنسان بالعالم.
بعبارة أخرى، إن نظام توزيع الصورة – بوصفها المادة الثقافية المعاصرة – على أوسع نطاق عالمي، لا يمكن اعتباره مجرد تقنية لـ”التلقين” فحسب؛ بل هو يتجاوز ذلك، ليمثل كيفية جديدة لوعى العالم والتعبير عنه. بمعنى إنه ليس مجرد وسيلة، بل هو – أكثر من ذلك – طريقة معينة لإدراك العالم والوعي به، والتعبير عنه.